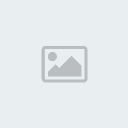بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة ، عاد الأنصار إلى المدينة ينتظرون هجرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إليهم بتلهف كبير . وأذن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن ، الذي اختاره الله مهجراً لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم .
ولم تكن الهجرة مجرد التخلص من إيذاء المشركين أو الفرار من الفتنة في الدين ، بل كانت كذلك إيذاناً بميلاد دولة الإسلام ، وإقامة مجتمع التوحيد الذي تهفوا إليه نفوس المؤمنين .
وإذا كان امتحان المسلمين قبل الهجرة متمثلاً في الإيذاء والتعذيب وتحمل ألوان السخرية والاستهزاء والتكذيب فإن الهجرة كانت تمثل امتحاناً ليس أقل ضراوة ، حيث سيترك المهاجر الأوطان والديار والقرابات والأموال ، والأصحاب والذكريات ، بل سيغامر بنفسه وربما فقدها في أثناء الطريق ، فقد سعت قريش بشتى الطرق إلى عرقلة الهجرة أمام المهاجرين ، مرة بحجز أموالهم ومنعهم من حملها ، ومرة بحجز زوجاتهم وأطفالهم ، وثالثة بالاحتيال لإعادتهم إلى مكة ، لكن شيئاً من ذلك كله ، لم يعق موكب الهجرة ، فالمهاجرون كانوا على أتم استعداد للانخلاع من أموالهم وأهليهم ودنياهم كلها تلبية لنداء العقيدة ، ونصرة لدين الله وتأسيساً وإقامة لمجتمع الإيمان .
لقد ضرب المسلمون بهجرتهم أروع أمثلة التضحية من أجل الدين ، فهذه أم سلمة تحكي قصة هجرتها مع زوجها وابنها ، وهم أول أهل بيت هاجر ، فلما رآه أصهاره مرتحلاً بأهله قالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ! أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسير بها في البلاد فأخذوا منه زوجته ! ، وغضب آل أبي سلمة لصاحبهم فقالوا : لا و الله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ! وتجاذبوا الغلام بينهم حتى خلعوا يده ! وانطلق أبو سلمة مهاجراً وحده إلى المدينة ، وحبست أم سلمة عند قومها وذهب قوم أبي سلمة بالولد ! قالت : ففُرِّق بيني وبين زوجي وبين ابني ! فكنت أخرج كل غداة بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي ، سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي فرحمني ، فقال لقومه ألا تخرجون هذه المسكينة ، فرَقتم بينها وبين زوجها وولدها ؟ فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت ، فاسترجعت ابنها من أعمامه ، وارتحلت بعيرها ، فخرجت بولدها تريد المدينة ما معها من أحد من خلق الله . وفي الطريق لقيها عثمان بن طلحة ، وكان مشركاً فأخذته مروءة العرب ونخوتهم فقال : ما لهذه من متْرَك فانطلق بها يقودها إلى المدينة ، كلما نزل منزلاً استأخر عنها مروءة . كما قال صاحبه الجاهلي :
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها
فلما وصل قباء قال : زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله ثم انصرف رجعاً إلى مكة . فكانت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ تقول : و الله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة . وما رأيت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة .
قصة هجرة عجيبة ، وأعجب منها موقف ذلك المشرك الذي صاحب هذه المرأة المسلمة التي ليست على دينه ليوصلها ، وأحسن معاملتها ، وغض بصره عنها طيلة خمسمائة من الكيلو مترات قطعها في أيام ، ثم عاد إلى مكة دون راحة . فأي مروءة ، وأي شهامة يتعلمها شباب المسلمون الآن من رجل كافر ملك نفسه وملك إرادته ، وغض بصره ، إنها سلامة الفطرة التي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية .
ولعل إضاءة قلبه بدأت منذ تلك الرحلة مع المرأة المسلمة .
ومن الصور المضيئة لتضحيات المهاجرين ـ رضي الله عنهم : هجرة صهيب ـ رضي الله عنه ـ فإنه لما أراد الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك عندنا ، وبلغت الذي بلغت ، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ! و الله لا يكون ذلك ! فقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي ، أتخلون سبيلي ؟ قالوا نعم ! قال : فإني قد جعلت لكم مالي . فبلغ ذلك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : ربح صهيب .
وهكذا أخذ المهاجرون يتركون مكة تباعاً ، حتى كادت تخلوا من المسلمين ، وشعرت قريش أن الإسلام أضحت له دار يأرز إليها ، وحصن يحتمي به ، فتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة في دعوة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهاجت في دمائها غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته فقررت قتل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للقضاء على الدعوة التي أقلقت مضاجعهم . فأخبر الله رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمكرهم { وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله ُ وَ الله ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } … (الأنفال:30) .
وأذن الله لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهجرة ، فجاء منزل أبي بكر نحو الظهيرة ، وقد اشتد الحر في وقت لا يخرج فيه أحد عادة . لقد عرف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن قريشاً ترصده فأراد أن يأخذ حذره ، وعندما أُخبر أبو بكر بقدومه في هذا الوقت ، عرف أن الأمر خطير ، ولما أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا بكر أن الله أذن له في الخروج ، قال : الصحبة يا رسول الله ؟ قال : الصحبة ! تقول عائشة : فو الله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي ! ووضع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطة الهجرة مراعياً ما يمكنه من أسباب دون تواكل على النصر الموعود .
فقد اتفق مع أبي بكر على الخروج ليلاً إلى غار ثور . ومن جهة غير الجهة المعتادة التي يذهب الناس إلى المدينة منها ، وأن يمكثا في الغار ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عنهما . واستأجرا دليلاً ماهراً بمسالك الصحراء ليقودهما إلى المدينة ، وقد استأمنه مع كونه مشركا ، ودفعا إليه راحلتيهما اللتين كان أعدهما أبو بكر لذلك . لكن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبى إلا أن يدفع ثمن راحلته كي يبذل في الهجرة من ماله كما يبذل من نفسه ! وزودتهما أسماء بالطعام .
وكان عبد الله ابن أبي بكر يتسمع لما يقوله الناس بالنهار ثم يخبرهما في الليل ، فيعفى عامر بن فهيرة على آثار قدميه بأن يروح بغنمه عليها . كما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ علياً أن يبيت في فراشه . ومع روعة التخطيط البشري واستفراغ الواسع ، وأخذ الحيطة البالغة ، إلا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما كان ليركن إلى الأسباب ، وإنما كان واثقاً بربه ، متوكلاً عليه ، موقناً بحسن تدبيره لنبيه ، ونصرته لدينه ، فحينما وجد فوارس قريش ، وقصاص الأثر في طلب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وانتشروا في الجبال والوديان ، وصل بعضهم إلى فم الغار ، حتى رأى الصديق أقدامهم ، فخاف على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن مستقبل الأمة متعلق به ، فقال : يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ رأسه لرآنا فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر : ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ ! وقد أثنى الله على ذلك اليقين والتوكل التام بقوله : { ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ الله َ مَعَنَا } ... (التوبة: من الآية40) .
ومن عظيم توكله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكمال يقينه ما جرى مع سراقة بن مالك ، الذي علم أن قريشاً جعلت مائة ناقة لمن يدل على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حياً أو ميتاً فتتبعهما بفرسه حتى دنا منهما ، وكان أبو بكر يكثر الالتفاف خوفاً على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإشفاقاً على الأمة أن تصاب في نبيها ، وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثابتاً لا يلتفت ، ولم يزد على أن قال لما علم بقرب سراقة : الله م اصرعه ! فاستجاب الله له ، فساخت قدما فرسه في الأرض . وعلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ممنوع ، وأنه ظاهر ، فطلب منه أن يكتب له كتاب أمان ، وعرض على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المساعدة ، فقال أخف عنا ! ، فأصبح أول النهار جاهداً عليهما ، وأمسى آخره حارساً لهما .
وواصل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رحلته إلى المدينة . وتعددت مظاهر عناية الله له . وظهرت دلائل بركته . واشتد شوق أهل المدينة إليه لما علموا بخروجه . فكانوا ينتظرونه كل يوم ، ولا يرجعون حتى يشتد الحر ، فلما شرفت المدينة بمقدمه ، لم يفرح الناس بشيء فرحهم برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى جعلت النساء والصبيان والإماء يقولون : جاء رسول الله ، جاء رسول الله .
ونزل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أخواله من بني النجار ، وعمت الفرحة أرجاء يثرب التي تغير فيها كل شيء منذ ذلك اليوم ، حتى اسمها ، إنها الآن المدينة المنورة ، مدينة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحتى سكانها ، إنهم الآن أنصار رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذين { يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة ، عاد الأنصار إلى المدينة ينتظرون هجرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إليهم بتلهف كبير . وأذن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن ، الذي اختاره الله مهجراً لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم .
ولم تكن الهجرة مجرد التخلص من إيذاء المشركين أو الفرار من الفتنة في الدين ، بل كانت كذلك إيذاناً بميلاد دولة الإسلام ، وإقامة مجتمع التوحيد الذي تهفوا إليه نفوس المؤمنين .
وإذا كان امتحان المسلمين قبل الهجرة متمثلاً في الإيذاء والتعذيب وتحمل ألوان السخرية والاستهزاء والتكذيب فإن الهجرة كانت تمثل امتحاناً ليس أقل ضراوة ، حيث سيترك المهاجر الأوطان والديار والقرابات والأموال ، والأصحاب والذكريات ، بل سيغامر بنفسه وربما فقدها في أثناء الطريق ، فقد سعت قريش بشتى الطرق إلى عرقلة الهجرة أمام المهاجرين ، مرة بحجز أموالهم ومنعهم من حملها ، ومرة بحجز زوجاتهم وأطفالهم ، وثالثة بالاحتيال لإعادتهم إلى مكة ، لكن شيئاً من ذلك كله ، لم يعق موكب الهجرة ، فالمهاجرون كانوا على أتم استعداد للانخلاع من أموالهم وأهليهم ودنياهم كلها تلبية لنداء العقيدة ، ونصرة لدين الله وتأسيساً وإقامة لمجتمع الإيمان .
لقد ضرب المسلمون بهجرتهم أروع أمثلة التضحية من أجل الدين ، فهذه أم سلمة تحكي قصة هجرتها مع زوجها وابنها ، وهم أول أهل بيت هاجر ، فلما رآه أصهاره مرتحلاً بأهله قالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ! أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسير بها في البلاد فأخذوا منه زوجته ! ، وغضب آل أبي سلمة لصاحبهم فقالوا : لا و الله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ! وتجاذبوا الغلام بينهم حتى خلعوا يده ! وانطلق أبو سلمة مهاجراً وحده إلى المدينة ، وحبست أم سلمة عند قومها وذهب قوم أبي سلمة بالولد ! قالت : ففُرِّق بيني وبين زوجي وبين ابني ! فكنت أخرج كل غداة بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي ، سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي فرحمني ، فقال لقومه ألا تخرجون هذه المسكينة ، فرَقتم بينها وبين زوجها وولدها ؟ فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت ، فاسترجعت ابنها من أعمامه ، وارتحلت بعيرها ، فخرجت بولدها تريد المدينة ما معها من أحد من خلق الله . وفي الطريق لقيها عثمان بن طلحة ، وكان مشركاً فأخذته مروءة العرب ونخوتهم فقال : ما لهذه من متْرَك فانطلق بها يقودها إلى المدينة ، كلما نزل منزلاً استأخر عنها مروءة . كما قال صاحبه الجاهلي :
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها
فلما وصل قباء قال : زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله ثم انصرف رجعاً إلى مكة . فكانت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ تقول : و الله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة . وما رأيت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة .
قصة هجرة عجيبة ، وأعجب منها موقف ذلك المشرك الذي صاحب هذه المرأة المسلمة التي ليست على دينه ليوصلها ، وأحسن معاملتها ، وغض بصره عنها طيلة خمسمائة من الكيلو مترات قطعها في أيام ، ثم عاد إلى مكة دون راحة . فأي مروءة ، وأي شهامة يتعلمها شباب المسلمون الآن من رجل كافر ملك نفسه وملك إرادته ، وغض بصره ، إنها سلامة الفطرة التي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية .
ولعل إضاءة قلبه بدأت منذ تلك الرحلة مع المرأة المسلمة .
ومن الصور المضيئة لتضحيات المهاجرين ـ رضي الله عنهم : هجرة صهيب ـ رضي الله عنه ـ فإنه لما أراد الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك عندنا ، وبلغت الذي بلغت ، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ! و الله لا يكون ذلك ! فقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي ، أتخلون سبيلي ؟ قالوا نعم ! قال : فإني قد جعلت لكم مالي . فبلغ ذلك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : ربح صهيب .
وهكذا أخذ المهاجرون يتركون مكة تباعاً ، حتى كادت تخلوا من المسلمين ، وشعرت قريش أن الإسلام أضحت له دار يأرز إليها ، وحصن يحتمي به ، فتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة في دعوة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهاجت في دمائها غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته فقررت قتل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للقضاء على الدعوة التي أقلقت مضاجعهم . فأخبر الله رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمكرهم { وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله ُ وَ الله ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } … (الأنفال:30) .
وأذن الله لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهجرة ، فجاء منزل أبي بكر نحو الظهيرة ، وقد اشتد الحر في وقت لا يخرج فيه أحد عادة . لقد عرف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن قريشاً ترصده فأراد أن يأخذ حذره ، وعندما أُخبر أبو بكر بقدومه في هذا الوقت ، عرف أن الأمر خطير ، ولما أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا بكر أن الله أذن له في الخروج ، قال : الصحبة يا رسول الله ؟ قال : الصحبة ! تقول عائشة : فو الله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي ! ووضع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطة الهجرة مراعياً ما يمكنه من أسباب دون تواكل على النصر الموعود .
فقد اتفق مع أبي بكر على الخروج ليلاً إلى غار ثور . ومن جهة غير الجهة المعتادة التي يذهب الناس إلى المدينة منها ، وأن يمكثا في الغار ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عنهما . واستأجرا دليلاً ماهراً بمسالك الصحراء ليقودهما إلى المدينة ، وقد استأمنه مع كونه مشركا ، ودفعا إليه راحلتيهما اللتين كان أعدهما أبو بكر لذلك . لكن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبى إلا أن يدفع ثمن راحلته كي يبذل في الهجرة من ماله كما يبذل من نفسه ! وزودتهما أسماء بالطعام .
وكان عبد الله ابن أبي بكر يتسمع لما يقوله الناس بالنهار ثم يخبرهما في الليل ، فيعفى عامر بن فهيرة على آثار قدميه بأن يروح بغنمه عليها . كما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ علياً أن يبيت في فراشه . ومع روعة التخطيط البشري واستفراغ الواسع ، وأخذ الحيطة البالغة ، إلا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما كان ليركن إلى الأسباب ، وإنما كان واثقاً بربه ، متوكلاً عليه ، موقناً بحسن تدبيره لنبيه ، ونصرته لدينه ، فحينما وجد فوارس قريش ، وقصاص الأثر في طلب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وانتشروا في الجبال والوديان ، وصل بعضهم إلى فم الغار ، حتى رأى الصديق أقدامهم ، فخاف على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن مستقبل الأمة متعلق به ، فقال : يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ رأسه لرآنا فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر : ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ ! وقد أثنى الله على ذلك اليقين والتوكل التام بقوله : { ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ الله َ مَعَنَا } ... (التوبة: من الآية40) .
ومن عظيم توكله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكمال يقينه ما جرى مع سراقة بن مالك ، الذي علم أن قريشاً جعلت مائة ناقة لمن يدل على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حياً أو ميتاً فتتبعهما بفرسه حتى دنا منهما ، وكان أبو بكر يكثر الالتفاف خوفاً على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإشفاقاً على الأمة أن تصاب في نبيها ، وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثابتاً لا يلتفت ، ولم يزد على أن قال لما علم بقرب سراقة : الله م اصرعه ! فاستجاب الله له ، فساخت قدما فرسه في الأرض . وعلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ممنوع ، وأنه ظاهر ، فطلب منه أن يكتب له كتاب أمان ، وعرض على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المساعدة ، فقال أخف عنا ! ، فأصبح أول النهار جاهداً عليهما ، وأمسى آخره حارساً لهما .
وواصل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رحلته إلى المدينة . وتعددت مظاهر عناية الله له . وظهرت دلائل بركته . واشتد شوق أهل المدينة إليه لما علموا بخروجه . فكانوا ينتظرونه كل يوم ، ولا يرجعون حتى يشتد الحر ، فلما شرفت المدينة بمقدمه ، لم يفرح الناس بشيء فرحهم برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى جعلت النساء والصبيان والإماء يقولون : جاء رسول الله ، جاء رسول الله .
ونزل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أخواله من بني النجار ، وعمت الفرحة أرجاء يثرب التي تغير فيها كل شيء منذ ذلك اليوم ، حتى اسمها ، إنها الآن المدينة المنورة ، مدينة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحتى سكانها ، إنهم الآن أنصار رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذين { يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ... (الحشر: من الآية9) .
ولم تكن الهجرة مجرد التخلص من إيذاء المشركين أو الفرار من الفتنة في الدين ، بل كانت كذلك إيذاناً بميلاد دولة الإسلام ، وإقامة مجتمع التوحيد الذي تهفوا إليه نفوس المؤمنين .
وإذا كان امتحان المسلمين قبل الهجرة متمثلاً في الإيذاء والتعذيب وتحمل ألوان السخرية والاستهزاء والتكذيب فإن الهجرة كانت تمثل امتحاناً ليس أقل ضراوة ، حيث سيترك المهاجر الأوطان والديار والقرابات والأموال ، والأصحاب والذكريات ، بل سيغامر بنفسه وربما فقدها في أثناء الطريق ، فقد سعت قريش بشتى الطرق إلى عرقلة الهجرة أمام المهاجرين ، مرة بحجز أموالهم ومنعهم من حملها ، ومرة بحجز زوجاتهم وأطفالهم ، وثالثة بالاحتيال لإعادتهم إلى مكة ، لكن شيئاً من ذلك كله ، لم يعق موكب الهجرة ، فالمهاجرون كانوا على أتم استعداد للانخلاع من أموالهم وأهليهم ودنياهم كلها تلبية لنداء العقيدة ، ونصرة لدين الله وتأسيساً وإقامة لمجتمع الإيمان .
لقد ضرب المسلمون بهجرتهم أروع أمثلة التضحية من أجل الدين ، فهذه أم سلمة تحكي قصة هجرتها مع زوجها وابنها ، وهم أول أهل بيت هاجر ، فلما رآه أصهاره مرتحلاً بأهله قالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ! أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسير بها في البلاد فأخذوا منه زوجته ! ، وغضب آل أبي سلمة لصاحبهم فقالوا : لا و الله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ! وتجاذبوا الغلام بينهم حتى خلعوا يده ! وانطلق أبو سلمة مهاجراً وحده إلى المدينة ، وحبست أم سلمة عند قومها وذهب قوم أبي سلمة بالولد ! قالت : ففُرِّق بيني وبين زوجي وبين ابني ! فكنت أخرج كل غداة بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي ، سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي فرحمني ، فقال لقومه ألا تخرجون هذه المسكينة ، فرَقتم بينها وبين زوجها وولدها ؟ فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت ، فاسترجعت ابنها من أعمامه ، وارتحلت بعيرها ، فخرجت بولدها تريد المدينة ما معها من أحد من خلق الله . وفي الطريق لقيها عثمان بن طلحة ، وكان مشركاً فأخذته مروءة العرب ونخوتهم فقال : ما لهذه من متْرَك فانطلق بها يقودها إلى المدينة ، كلما نزل منزلاً استأخر عنها مروءة . كما قال صاحبه الجاهلي :
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها
فلما وصل قباء قال : زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله ثم انصرف رجعاً إلى مكة . فكانت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ تقول : و الله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة . وما رأيت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة .
قصة هجرة عجيبة ، وأعجب منها موقف ذلك المشرك الذي صاحب هذه المرأة المسلمة التي ليست على دينه ليوصلها ، وأحسن معاملتها ، وغض بصره عنها طيلة خمسمائة من الكيلو مترات قطعها في أيام ، ثم عاد إلى مكة دون راحة . فأي مروءة ، وأي شهامة يتعلمها شباب المسلمون الآن من رجل كافر ملك نفسه وملك إرادته ، وغض بصره ، إنها سلامة الفطرة التي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية .
ولعل إضاءة قلبه بدأت منذ تلك الرحلة مع المرأة المسلمة .
ومن الصور المضيئة لتضحيات المهاجرين ـ رضي الله عنهم : هجرة صهيب ـ رضي الله عنه ـ فإنه لما أراد الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك عندنا ، وبلغت الذي بلغت ، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ! و الله لا يكون ذلك ! فقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي ، أتخلون سبيلي ؟ قالوا نعم ! قال : فإني قد جعلت لكم مالي . فبلغ ذلك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : ربح صهيب .
وهكذا أخذ المهاجرون يتركون مكة تباعاً ، حتى كادت تخلوا من المسلمين ، وشعرت قريش أن الإسلام أضحت له دار يأرز إليها ، وحصن يحتمي به ، فتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة في دعوة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهاجت في دمائها غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته فقررت قتل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للقضاء على الدعوة التي أقلقت مضاجعهم . فأخبر الله رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمكرهم { وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله ُ وَ الله ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } … (الأنفال:30) .
وأذن الله لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهجرة ، فجاء منزل أبي بكر نحو الظهيرة ، وقد اشتد الحر في وقت لا يخرج فيه أحد عادة . لقد عرف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن قريشاً ترصده فأراد أن يأخذ حذره ، وعندما أُخبر أبو بكر بقدومه في هذا الوقت ، عرف أن الأمر خطير ، ولما أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا بكر أن الله أذن له في الخروج ، قال : الصحبة يا رسول الله ؟ قال : الصحبة ! تقول عائشة : فو الله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي ! ووضع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطة الهجرة مراعياً ما يمكنه من أسباب دون تواكل على النصر الموعود .
فقد اتفق مع أبي بكر على الخروج ليلاً إلى غار ثور . ومن جهة غير الجهة المعتادة التي يذهب الناس إلى المدينة منها ، وأن يمكثا في الغار ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عنهما . واستأجرا دليلاً ماهراً بمسالك الصحراء ليقودهما إلى المدينة ، وقد استأمنه مع كونه مشركا ، ودفعا إليه راحلتيهما اللتين كان أعدهما أبو بكر لذلك . لكن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبى إلا أن يدفع ثمن راحلته كي يبذل في الهجرة من ماله كما يبذل من نفسه ! وزودتهما أسماء بالطعام .
وكان عبد الله ابن أبي بكر يتسمع لما يقوله الناس بالنهار ثم يخبرهما في الليل ، فيعفى عامر بن فهيرة على آثار قدميه بأن يروح بغنمه عليها . كما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ علياً أن يبيت في فراشه . ومع روعة التخطيط البشري واستفراغ الواسع ، وأخذ الحيطة البالغة ، إلا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما كان ليركن إلى الأسباب ، وإنما كان واثقاً بربه ، متوكلاً عليه ، موقناً بحسن تدبيره لنبيه ، ونصرته لدينه ، فحينما وجد فوارس قريش ، وقصاص الأثر في طلب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وانتشروا في الجبال والوديان ، وصل بعضهم إلى فم الغار ، حتى رأى الصديق أقدامهم ، فخاف على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن مستقبل الأمة متعلق به ، فقال : يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ رأسه لرآنا فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر : ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ ! وقد أثنى الله على ذلك اليقين والتوكل التام بقوله : { ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ الله َ مَعَنَا } ... (التوبة: من الآية40) .
ومن عظيم توكله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكمال يقينه ما جرى مع سراقة بن مالك ، الذي علم أن قريشاً جعلت مائة ناقة لمن يدل على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حياً أو ميتاً فتتبعهما بفرسه حتى دنا منهما ، وكان أبو بكر يكثر الالتفاف خوفاً على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإشفاقاً على الأمة أن تصاب في نبيها ، وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثابتاً لا يلتفت ، ولم يزد على أن قال لما علم بقرب سراقة : الله م اصرعه ! فاستجاب الله له ، فساخت قدما فرسه في الأرض . وعلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ممنوع ، وأنه ظاهر ، فطلب منه أن يكتب له كتاب أمان ، وعرض على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المساعدة ، فقال أخف عنا ! ، فأصبح أول النهار جاهداً عليهما ، وأمسى آخره حارساً لهما .
وواصل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رحلته إلى المدينة . وتعددت مظاهر عناية الله له . وظهرت دلائل بركته . واشتد شوق أهل المدينة إليه لما علموا بخروجه . فكانوا ينتظرونه كل يوم ، ولا يرجعون حتى يشتد الحر ، فلما شرفت المدينة بمقدمه ، لم يفرح الناس بشيء فرحهم برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى جعلت النساء والصبيان والإماء يقولون : جاء رسول الله ، جاء رسول الله .
ونزل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أخواله من بني النجار ، وعمت الفرحة أرجاء يثرب التي تغير فيها كل شيء منذ ذلك اليوم ، حتى اسمها ، إنها الآن المدينة المنورة ، مدينة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحتى سكانها ، إنهم الآن أنصار رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذين { يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة ، عاد الأنصار إلى المدينة ينتظرون هجرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إليهم بتلهف كبير . وأذن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن ، الذي اختاره الله مهجراً لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم .
ولم تكن الهجرة مجرد التخلص من إيذاء المشركين أو الفرار من الفتنة في الدين ، بل كانت كذلك إيذاناً بميلاد دولة الإسلام ، وإقامة مجتمع التوحيد الذي تهفوا إليه نفوس المؤمنين .
وإذا كان امتحان المسلمين قبل الهجرة متمثلاً في الإيذاء والتعذيب وتحمل ألوان السخرية والاستهزاء والتكذيب فإن الهجرة كانت تمثل امتحاناً ليس أقل ضراوة ، حيث سيترك المهاجر الأوطان والديار والقرابات والأموال ، والأصحاب والذكريات ، بل سيغامر بنفسه وربما فقدها في أثناء الطريق ، فقد سعت قريش بشتى الطرق إلى عرقلة الهجرة أمام المهاجرين ، مرة بحجز أموالهم ومنعهم من حملها ، ومرة بحجز زوجاتهم وأطفالهم ، وثالثة بالاحتيال لإعادتهم إلى مكة ، لكن شيئاً من ذلك كله ، لم يعق موكب الهجرة ، فالمهاجرون كانوا على أتم استعداد للانخلاع من أموالهم وأهليهم ودنياهم كلها تلبية لنداء العقيدة ، ونصرة لدين الله وتأسيساً وإقامة لمجتمع الإيمان .
لقد ضرب المسلمون بهجرتهم أروع أمثلة التضحية من أجل الدين ، فهذه أم سلمة تحكي قصة هجرتها مع زوجها وابنها ، وهم أول أهل بيت هاجر ، فلما رآه أصهاره مرتحلاً بأهله قالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ! أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسير بها في البلاد فأخذوا منه زوجته ! ، وغضب آل أبي سلمة لصاحبهم فقالوا : لا و الله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ! وتجاذبوا الغلام بينهم حتى خلعوا يده ! وانطلق أبو سلمة مهاجراً وحده إلى المدينة ، وحبست أم سلمة عند قومها وذهب قوم أبي سلمة بالولد ! قالت : ففُرِّق بيني وبين زوجي وبين ابني ! فكنت أخرج كل غداة بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي ، سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي فرحمني ، فقال لقومه ألا تخرجون هذه المسكينة ، فرَقتم بينها وبين زوجها وولدها ؟ فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت ، فاسترجعت ابنها من أعمامه ، وارتحلت بعيرها ، فخرجت بولدها تريد المدينة ما معها من أحد من خلق الله . وفي الطريق لقيها عثمان بن طلحة ، وكان مشركاً فأخذته مروءة العرب ونخوتهم فقال : ما لهذه من متْرَك فانطلق بها يقودها إلى المدينة ، كلما نزل منزلاً استأخر عنها مروءة . كما قال صاحبه الجاهلي :
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها
فلما وصل قباء قال : زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله ثم انصرف رجعاً إلى مكة . فكانت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ تقول : و الله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة . وما رأيت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة .
قصة هجرة عجيبة ، وأعجب منها موقف ذلك المشرك الذي صاحب هذه المرأة المسلمة التي ليست على دينه ليوصلها ، وأحسن معاملتها ، وغض بصره عنها طيلة خمسمائة من الكيلو مترات قطعها في أيام ، ثم عاد إلى مكة دون راحة . فأي مروءة ، وأي شهامة يتعلمها شباب المسلمون الآن من رجل كافر ملك نفسه وملك إرادته ، وغض بصره ، إنها سلامة الفطرة التي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية .
ولعل إضاءة قلبه بدأت منذ تلك الرحلة مع المرأة المسلمة .
ومن الصور المضيئة لتضحيات المهاجرين ـ رضي الله عنهم : هجرة صهيب ـ رضي الله عنه ـ فإنه لما أراد الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك عندنا ، وبلغت الذي بلغت ، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ! و الله لا يكون ذلك ! فقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي ، أتخلون سبيلي ؟ قالوا نعم ! قال : فإني قد جعلت لكم مالي . فبلغ ذلك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : ربح صهيب .
وهكذا أخذ المهاجرون يتركون مكة تباعاً ، حتى كادت تخلوا من المسلمين ، وشعرت قريش أن الإسلام أضحت له دار يأرز إليها ، وحصن يحتمي به ، فتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة في دعوة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهاجت في دمائها غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته فقررت قتل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للقضاء على الدعوة التي أقلقت مضاجعهم . فأخبر الله رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمكرهم { وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله ُ وَ الله ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } … (الأنفال:30) .
وأذن الله لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهجرة ، فجاء منزل أبي بكر نحو الظهيرة ، وقد اشتد الحر في وقت لا يخرج فيه أحد عادة . لقد عرف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن قريشاً ترصده فأراد أن يأخذ حذره ، وعندما أُخبر أبو بكر بقدومه في هذا الوقت ، عرف أن الأمر خطير ، ولما أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا بكر أن الله أذن له في الخروج ، قال : الصحبة يا رسول الله ؟ قال : الصحبة ! تقول عائشة : فو الله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي ! ووضع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطة الهجرة مراعياً ما يمكنه من أسباب دون تواكل على النصر الموعود .
فقد اتفق مع أبي بكر على الخروج ليلاً إلى غار ثور . ومن جهة غير الجهة المعتادة التي يذهب الناس إلى المدينة منها ، وأن يمكثا في الغار ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عنهما . واستأجرا دليلاً ماهراً بمسالك الصحراء ليقودهما إلى المدينة ، وقد استأمنه مع كونه مشركا ، ودفعا إليه راحلتيهما اللتين كان أعدهما أبو بكر لذلك . لكن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبى إلا أن يدفع ثمن راحلته كي يبذل في الهجرة من ماله كما يبذل من نفسه ! وزودتهما أسماء بالطعام .
وكان عبد الله ابن أبي بكر يتسمع لما يقوله الناس بالنهار ثم يخبرهما في الليل ، فيعفى عامر بن فهيرة على آثار قدميه بأن يروح بغنمه عليها . كما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ علياً أن يبيت في فراشه . ومع روعة التخطيط البشري واستفراغ الواسع ، وأخذ الحيطة البالغة ، إلا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما كان ليركن إلى الأسباب ، وإنما كان واثقاً بربه ، متوكلاً عليه ، موقناً بحسن تدبيره لنبيه ، ونصرته لدينه ، فحينما وجد فوارس قريش ، وقصاص الأثر في طلب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وانتشروا في الجبال والوديان ، وصل بعضهم إلى فم الغار ، حتى رأى الصديق أقدامهم ، فخاف على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن مستقبل الأمة متعلق به ، فقال : يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ رأسه لرآنا فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر : ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ ! وقد أثنى الله على ذلك اليقين والتوكل التام بقوله : { ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ الله َ مَعَنَا } ... (التوبة: من الآية40) .
ومن عظيم توكله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكمال يقينه ما جرى مع سراقة بن مالك ، الذي علم أن قريشاً جعلت مائة ناقة لمن يدل على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حياً أو ميتاً فتتبعهما بفرسه حتى دنا منهما ، وكان أبو بكر يكثر الالتفاف خوفاً على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإشفاقاً على الأمة أن تصاب في نبيها ، وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثابتاً لا يلتفت ، ولم يزد على أن قال لما علم بقرب سراقة : الله م اصرعه ! فاستجاب الله له ، فساخت قدما فرسه في الأرض . وعلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ممنوع ، وأنه ظاهر ، فطلب منه أن يكتب له كتاب أمان ، وعرض على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المساعدة ، فقال أخف عنا ! ، فأصبح أول النهار جاهداً عليهما ، وأمسى آخره حارساً لهما .
وواصل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رحلته إلى المدينة . وتعددت مظاهر عناية الله له . وظهرت دلائل بركته . واشتد شوق أهل المدينة إليه لما علموا بخروجه . فكانوا ينتظرونه كل يوم ، ولا يرجعون حتى يشتد الحر ، فلما شرفت المدينة بمقدمه ، لم يفرح الناس بشيء فرحهم برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى جعلت النساء والصبيان والإماء يقولون : جاء رسول الله ، جاء رسول الله .
ونزل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أخواله من بني النجار ، وعمت الفرحة أرجاء يثرب التي تغير فيها كل شيء منذ ذلك اليوم ، حتى اسمها ، إنها الآن المدينة المنورة ، مدينة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحتى سكانها ، إنهم الآن أنصار رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذين { يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ... (الحشر: من الآية9) .


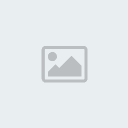




 الموقع
الموقع